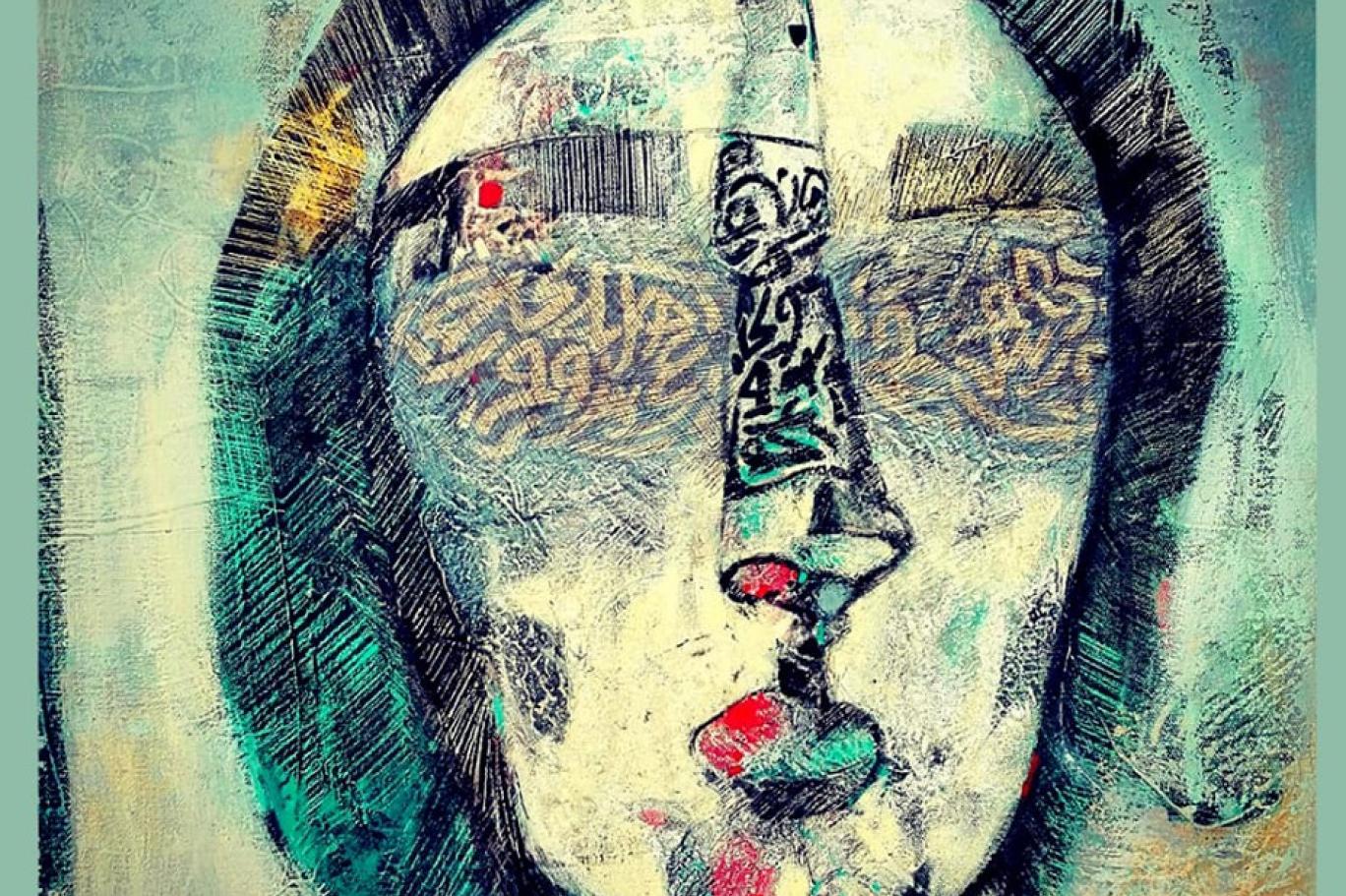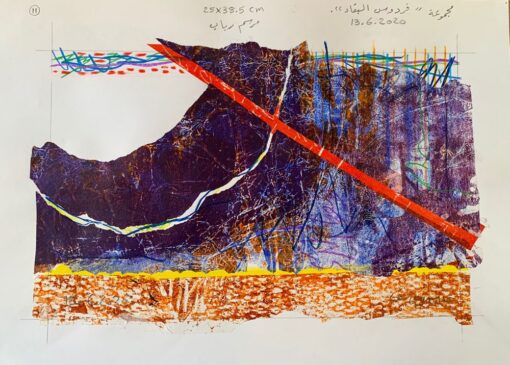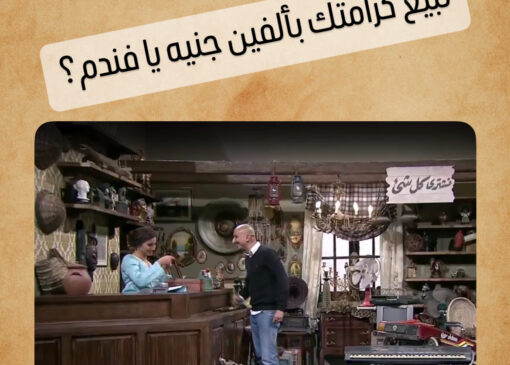“وهم التنوير” مرة أخرى.. ردٌّ بعد ردّ
قرأتُ بعناية مقالة الأستاذ بدر العبري، التي جاءت تعليقاً على مقالي “وهم التنوير”، وأقدّر حرصه على النقاش، وتقديمه قراءة مخالفة تنطلق من رؤية مغايرة، ما يدل على حيوية الحوار الفكري.
ربما احتاج المقال إلى توضيح ما التُبس على البعض، أو فُهم على غير مقصده، خصوصاً حين تُطرح أسئلة من قبيل: “ما علاقة التنوير بما تقوم به إسرائيل من قتل وبطش؟”، و”هل إسرائيل تُقدّم نفسها كأنموذج تنويري فعلاً؟”.
لم يكن الهدف من المقالة اتهام التنوير بوصفه مشروعاً فكرياً وفلسفياً واسع التأثير، بأنه يدعو إلى القتل أو يبرّره، كما لم تكن غايتي القول إن إسرائيل تمثل تجسيداً (نقياً) لمفهوم التنوير. بل ما وُجه إليه النقد هو هذا التحوّل الذي أصاب المفاهيم الغربية الكبرى، ومنها التنوير، حين خرجت من سياقها الفلسفي التأملي، لتدخل في منظومات القوة والهيمنة، وتُستخدم في تبرير السياسات الاستعمارية الجديدة أو التغطية عليها.
ومن هنا، تحديدًا، جاء عنوان المقالة: “وهم التنوير”. كلمة وهم هنا ليست اعتباطية ولا استفزازية، بل تشير إلى حالة فكرية تتجاوز الخطأ العارض أو التوظيف السيء.
الوهم هو تصديق ما نتمنّى أن يكون، لا ما هو كائن بالفعل. هو ما يسيطر على أذهاننا، حتى لا نعود قادرين على مساءلته أو التشكيك فيه. أن نظلّ نُضفي على مفهوم ما، أو فكرة ما، معاني نقيّة خالصة، رغم غياب مدلولات نقائها عن أرض الواقع، نُكذّب ما نلمسه بحواسنا وما تراه أعيننا، كي لا نُسقط تلك الصورة المثالية، الجميلة، الحالمة التي نعلّق بها آمالنا.
الوهم الأخطر، هو ذلك الذي يظهر لنا بأنه الخلاص المطلق لكل مشاكلنا؛ النور الذي يبدد ظلامنا، العلم الذي ينهي جهلنا، الفكر الذي يمسح تخلفنا، فيمنحنا بإيماننا به، شعورًا بالتفوق الأخلاقي والمعرفي، فلا نعود نجرؤ حتى على مساءلته.
نحن نعيش وهم التنوير لأننا كثيرًا ما نتّهم ذواتنا بالتخلّف، ونجلد مجتمعاتنا بالظلامية، لكن قلّما نمتلك الجرأة على مساءلة “المركز المعرفي” الذي حدد لنا معايير التقدّم. فإذا كان معنى التنوير هو، كما قال كانط: “خروج الإنسان من قصوره الذي ارتكبه في حق نفسه”، فإننا نقع في القصور ذاته الذي أراد التنوير تجاوزه، حين نرفض الشكّ، أو مصادرة السؤال، أو افتراض أن التنوير ذاته بمنأى عن المساءلة.
عندما نقول “وهم التنوير”، فهذا ليس إنكاراً لأهميته في تاريخ الفكر، ولا رفضاً لمبدأ نقد السلطة أو تحطيم الأصنام الفكرية، بل فضحٌ لوهمٍ معاصرٍ يرى في التنوير مخلِّصاً مطلقاً، ويغفل عن تحوّلاته التاريخية وارتباطه البنيوي في أحيان كثيرة بمشاريع القوة، مثل بعض الأنظمة الغربية التي تستخدم مفردات التنوير نفسها لتبرير تدخلاتها في العالم، تحت شعارات الحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، بينما كانت في الواقع تكرّس الظلم، أو تتواطأ مع القمع.
التنوير والأديان..
أما تشبيه نقد التنوير بالنقد الذي يُوجَّه للأديان حين تُستغل نصوصها في التبرير، فهو قياس فيه خلط. لأن التنوير مشروع عقلاني بشري يقدّم نفسه بوصفه معيارًا للتفكير النقدي والتقدم، ويُفترض أن يكون قابلاً للمساءلة التاريخية، بخلاف الأديان التي تستند إلى مرجعيات غيبية تتعلّق بالإيمان، وهي منظومة مختلفة تماماً.
لهذا يقال دائماً “لا تحاكم الدين بأدوات العلم، ولا تحاكم العلم بأدوات الدين”. لأنك إذا حاكمت الدين بمنهج العلم التجريبي، ستُسقط الإيمان والوحي والمعجزات والروح وكل ما هو غيبي. وإذا حاكمت العلم بمنطق الغيبيات، ستُفسِّر كل ظاهرة طبيعية على أنها معجزة أو عقوبة. لا يصحّ أن نحاكم منظومتين مختلفتين بمقاييس بعضهما.
التنوير مشروع بشري، لهذا هو مسؤول عن نتائجه، ويجب أن يحاكَم بأدواته التي تأسس عليها، ومناهجه قام عليها، ومنظومته التي تم الترويج له عبرها، ومؤسساته التي أصدرت حكمها على الآخرين من خلاله، ولا يمكن حمايته من النقد بحجة أن هناك من استغله.
حين يُمنع أكاديمي من التدريس لأنه انتقد إسرائيل، أو يُفصل صحفي لأنه استنكر إبادة شعب، أو تُلاحق حركة احتجاجية لأنها تتهم الغرب بالكيل بمكيالين، فإن السؤال لا يعود: هل هذه الأفعال صادرة عن “روح التنوير”؟ بل: لماذا تصمت المؤسسات التي تدّعي تمثيل هذا التنوير؟ ولماذا لا نرى ذات الحماسة التي نراها في قضايا أخرى أقل فداحة؟
ليس كل من صمت عن المذابح شريكاً فيها، ولكن حين يكون الصمت ممن يملك سلطة الكلمة، ويحتكر مفاتيح الخطاب، فإن صمته ليس حياداً بل موقف. والمقالة أشارت إلى هذا التواطؤ البنيوي الذي يجعل من إسرائيل “المسكوت عنه” في منظومات التنوير المعاصر، لا بسبب جهل العالم بجرائمها، بل لأن هذه الجرائم تحدث في نطاق نظام عالمي يُعيد تعريف المفاهيم بما يخدم مصالحه.
أما الاستشهاد بوجود مفكرين غربيين وقفوا ضد إسرائيل، أو خرجوا في مظاهرات داعمة لغزة، فهو أمر لا أنكره، بل أراه جزءاً من النور الباقي في العالم. لكن السؤال ليس عن الأفراد بل عن المنظومة، وليس عن مواقف شخصية بل عن السياسات المُنتَجة خطابياً ومؤسساتياً.
وجود نماذج مشرفة لا يعني أن الخطاب الغالب سليم، تماماً كما لا يمكن تبرئة نظام بأكمله لأن فيه قضاة نزهاء.
أردتُ من خلال المقالة أن أُنبّه إلى ما يمكن تسميته “الوجوه الباردة للمفاهيم”، تلك التي تفقد وهجها الأخلاقي حين تصبح أدوات لتجميل القبح، أو تُستخدم بانتقائية مفرطة، فتُستنفر من أجل فرد وتُسكت أمام إبادة شعب. وهذا ما ينبغي أن يُراجع، لا من أجل إسقاط التنوير، بل لإنقاذ معانيه التي نتمناها، أن تكون قائمة بالفعل، لا في أذهاننا، بل في الواقع، بدلاً من العيش في وهم الزيف والتوظيف.
أخيراً، ما كتبته رؤية ذاتية منفتحة على النقد والمراجعة، والشكر لكل من تعنّى بالرد أو التعليق أو النشر، أو التواصل عبر الوسائل المختلفة.
لقراءة مقال الأستاذ بدر العبري https://baderalabri.com/?p=2784